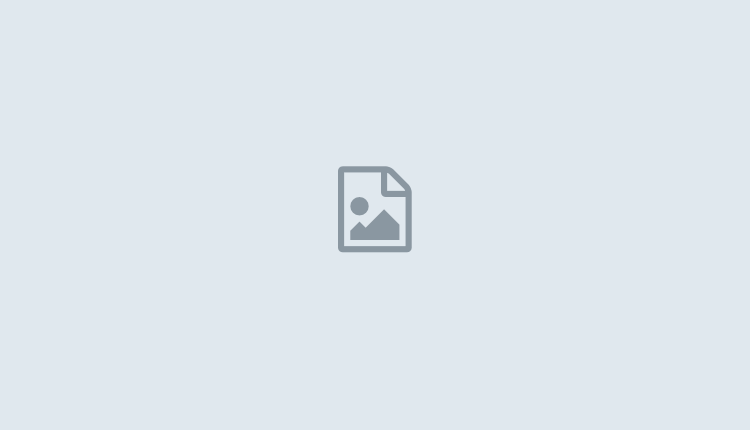أجرى الحوار: د. توفيق رفيق التونچي
أنا ما زلتُ في المنفى، أعني ما زلت أحيا كل لحظة في الوطن.
الشاعرة باهرة عبد اللطيف
المنفى كذاك الختم الأسطواني الذي اخترعه أبناء الرافدين. قارئي الكريم، لا تزال تلك الأسطوانة تتدحرج على رمال الزمن تاركة إرثا ثقافيا خالدا للأجيال القادمة. اليوم أحاور إنسانة رقيقة كشغاف القلب عن المنفى والشعر هي الشاعرة باهرة عبد اللطيف وسفر التغرب والمنفى.
المنفى
عقربا ساعةٍ
مسمومان
يلدغانِ القلبَ
كلّما خَفتَ نبضُ حنينهِ
يدورانِ متعاكسيْنِ
أحدُهما يقطعُ الزّمنَ
بهمةٍ
والآخرُ يعودُ بهِ
إلى مبتداه..
لكل منا في المنفى رواية نرويها لأحبتنا وبلغة المنفى ومفرداتها وربما لأطفالنا والأحفاد . العديد ممن هاجروا اوطانهم تمكنوا من تقديم انتاج إبداعي في كافة مجالات الحياة والأديب تمكن في المنفى من ايجاد لغة جديدة بمفردات جديدة لا يفقهها الا من سكن المنفى وعاش أيامها بحلوه ومره . الشاعرة باهرة عبد اللطيف تركت بغداد ورحلت عن وطن غابت فيه الحكمة والعقل الرزين وبات في أتون الحرب وثقافة العنف وغياب التسامح والتروي في اتخاذ القرار، التقيت بها لتحدثنا اليوم عن تجربتها في الحياة والأدب في المنفى.
تقول شاعرتنا :
تسألني عن الغربة، وأنا أحسبها منفى. هذا الموضوع استغرق خمسة وعشرين عاماً من حياتي وما زلت اسأل نفسي كل يوم عن سبب وجودي خارج وطني، لأصل إلى قناعة تتلخص في كون الأمر مرهوناً أولاً وأخيراً بفكرة العودة. أعني إن كان للمرء الحرية في العودة إلى الوطن متى شاء فهي غربة واغتراب، وإن تعذرت أو استحالت فهو إذن منفى.
أنا أتحدث عن حياة كاملة موازية لحياة أخرى كان يفترض أن أعيشها في الوطن الذي اضطررت لمغادرته لأسباب موضوعية حتّمت علي الرحيل، وما زالت قائمة تحول دون عودتي. بهذا المعنى أنا منفية وإن كان ذلك قد بدأ قبل ربع قرن بقرار مني احتجاجاً على حصارين: حصار الداخل المتمثل بالديكتاتورية، وحصار الخارج المتمثل بالحظر الاقتصادي المفروض على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمنفّذ من خلال قرارات الأمم المتحدة. وكان حصاراً قاتلاً عاناه العراقيون استمر 13 عاماً بتدمير منهجي منظم وضراوة عز نظيرها في تاريخنا الحديث، شهدت شخصياً بضعة أعوام منه.
في أعقاب الغزو الأمريكي على العراق وسقوط النظام الديكتاتوري فكرت في مسألة العودة شأني في ذلك شأن الكثير من العراقيين في مغترباتهم، إلا أن موقفي الرافض للاحتلال الأمريكي بتداعياته ونتائجه – طغيان الفساد الحكومي المتعاقب والمحاصصة الطائفية المدمرة- أرجأ عودتي. إن مجرد التفكير في عدم القدرة على العودة والالتئام في السياق الحالي للوطن والعجز عن مواصلة الحلم والإنجاز، فيه ومن أجله، يشعرني بحصار المنفى. كما أن حالة الخراب العميم للوطن على أيدي المحتلين (الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى) منذ غزو عام 2003 حتى اليوم، والعمالة والتخادم واللصوصية المتغولة التي تتحكم بمقادير البلاد وتدفعها إلى الانحطاط يوما بعد آخر، كلها تصيبني بالاختناق الدائم حتى وأنا خارجه.
وهنا لا بد لي أيضاً من التوكيد على أن مفهوم المنفى النفسي لا يقتصر على من يجد نفسه مغترباً جغرافياً عن الوطن فحسب، إذ ثمة منفيون كثر داخل الوطن أيضاً من مثقفين، أو محض مواطنين بسطاء، يعيشون خارجه نفسياً لأن إراداتهم وحرياتهم مصادرة وحيواتهم مهددة.
الحياة الجديدة في المغتربات لها أفقها الواعد، وهنا أعني مناخ الحرية الذي نسعى إليه. إلا أن الشرط المادي لهذه المجتمعات قاسٍ يفقدك حريتك، لأنه يرغمك على الانطلاق من صفر جديد، ويفرض عليك جهداً وأعواماً من الكدح، سعياً لسد احتياجاتك ومتطلبات حياتك. كما أنه يعمق أحياناً من أزمة هويتك إزاء هوية الآخر المنغلق، القادم تحديداً من عقليات يمينية متعصبة ودينية متطرفة لا تقل تخلفاً عما موجود في بلداننا. الفارق الوحيد هو أن سلطة القوانين في البلدان الغربية هي التي تردع الأشخاص، وغيابها لدينا هو ما يطلق لها العنان. من هنا تصبح لقمة العيش حاجة دائمة، تعترضها معوقات تشغلك وتجعلك تشتبك في صراع دائم مع روحك التواقة للدرس والمعرفة والاطلاع على ثقافة الآخر. ويشتد هذا الصراع وتتعمق أزمة الروح والوعي حين يقف المرء بعصامية وحيداً بلا جهة تدعمه
للمنفى مخالبُ تستطيلُ كلّ ليلةٍ
وروحٌ تجأرُ بالاشتياق
لسمائِهِ ظلمةٌ مديدةٌ
وعيونٌ تهملُ بالبكاء
كلّما لاحَ في الأفقِ
نجمٌ
مرَّ سهواً
بالعراق..
تمكن الأديب في المنفى من إيجاد لغة جديدة بمفردات جديدة لا يفقهها الا من سكن المنفى وعاش أيامها بحلوه ومره.
هذا صحيح لأن التجربة الفردية للمنفي أو المغترب والمعاناة التي ترافقه طوال الوقت من أجل الحفاظ على الهوية الأصلية، وفي الوقت نفسه التفاعل مع ثقافات إنسانية أخرى، هي قاسم مشترك يجهله من لم يخض تجربة العيش خارج الوطن. أنا هنا لا أتحدث عمن اختار الاغتراب لأسباب مادية حياتية بلا هواجس أخرى، فهؤلاء غالباً ما يعيشون على هامش المجتمعات الغربية، ضعفاً وانكساراً أو حنيناً لما خلفوه وراءهم، وغالباً ما تدور حياتهم ضمن (غيتوهات) يصنعونها هم أنفسهم. لقد راقبتهم وهم يحيون على هامش المجتمعات المستقبلة، يرتادون الأمكنة نفسها، ويتناولون الأطعمة نفسها، ويتحدثون بلغتهم الأم ومفرداتها التي تضاءلت في الغربة، عاجزين – أو رافضين في لا وعيهم- عن تعلم لغة البلد الجديد وإتقانها. وقد لفت نظري أن هذه الفئة من المغتربين قد أضاعت فرصة التطور الاجتماعي في بلدانها الاصلية، كما أنها بددت فرصة عظيمة للتفاعل مع المجتمعات الغربية التي استقبلتهم، وهكذا تجدهم وقد توقفوا عن النمو اجتماعيا وثقافياً.
هناك دوما تحدياً في التقاء الثقافات المتباينة كيف وفقت في الجمع بين الثقافة الشرقية والغربية.
الحياة الجديدة في المغتربات لها أفقها الواعد، وهنا أعني مناخ الحرية الذي نسعى إليه. إلا أن الشرط المادي لهذه المجتمعات قاسٍ يفقدك حريتك، لأنه يرغمك على الانطلاق من صفر جديد، ويفرض عليك جهداً وأعواماً من الكدح، سعياً لسد احتياجاتك ومتطلبات حياتك. كما أنه يعمق أحياناً من أزمة هويتك إزاء هوية الآخر المنغلق، القادم تحديداً من عقليات يمينية متعصبة ودينية متطرفة لا تقل تخلفاً عما موجود في بلداننا. الفارق الوحيد هو أن سلطة القوانين في البلدان الغربية هي التي تردع الأشخاص، وغيابها لدينا هو ما يطلق لها العنان. من هنا تصبح لقمة العيش حاجة دائمة، تعترضها معوقات تشغلك وتجعلك تشتبك في صراع دائم مع روحك التواقة للدرس والمعرفة والاطلاع على ثقافة الآخر. ويشتد هذا الصراع وتتعمق أزمة الروح والوعي حين يقف المرء بعصامية وحيداً بلا جهة تدعمه..
مع ذلك، ولحسن حظي، اندمجت سريعاً في المجتمع الأسباني بسبب تخصصي في الأدب واللغة الأسبانيين، فقد كنت أمتلك أهم مفتاحين للاندماج والتفاعل الاجتماعي وهما: اللغة والثقافة. وقد تفاعلت وما أزال مع المثقفين والكتاب والأكاديميين والمستعربين الأسبان، في جو من الود والاحترام المتبادل. وبعد هذه الأعوام الطويلة أجدني سعيدة بينهم لأن مشتركاتنا الإنسانية والعملية كثيرة، وممتنة لكل ما تعلمته منهم ومن المحيط الثقافي والاجتماعي الأسباني الذي اغتنيت به إنسانة وكاتبة.
لكن، قبل ذلك كان عليّ أن أشرع في عملية غربلة وتفحص مليّ لجميع حمولاتي الثقافية والمعرفية وإرثي الاجتماعي أيضاً، وهي مسيرة شاقة مستمرة، لا تتوقف. وهكذا احتفظت بالإنساني الصالح منه ونبذت الكثير مما لا أراه جديراً بالحفاظ عليه. وفعلت الشيء نفسه مع البيئة الأسبانية الجديدة. اخترتُ منها ما يغني معارفي ويثريها، وبتمحيص شديد أيضاً. فأنا لم أشعر يوماً باضطراري لقبول ثقافة الآخر حد التطابق معها أو حد إمحاء الهوية، بل كنت وما زلت مدركة لضرورة التحاور والتفاعل معها بندية بما يغني الطرفين.
لقد حاولت، من خلال تدريسي الأدب الاسباني في جامعة بغداد ومن ثم تدريس الترجمة الفورية والتحريرية واللغة والأدب العربي في الجامعات الاسبانية، أن أغرس في نفوس طلابي هذا الوعي وهذا الاهتمام بالمشتركات الإنسانية التي تجمعنا كأبناء لثقافتين، شرقية وغربية، تتكاملان وتغتنيان ببعضهما البعض، لنتحاور كأنداد بحرية واحترام. المهم أن نكون قنطرة ثقافية بين عالمين وثقافتين، وهذا ما نقلته بحب وحرص إلى طلابي في كلا التجربتين.
لا ننسى هنا أن الثقافة الأسبانية تضم من الإرث الثقافي العربي والإسلامي ما يجعلها مختلفة عن أي بلد أوروبي آخر. ويبقى المهم دائماً أن نحسن قراءة الماضي والتفاعل مع الآخر حاضراً لنغتني جميعاً.
لكل منا في المنفى رواية نرويها لأحبتنا وربما لأطفالنا والأحفاد.
من فضائل المنفى أيضاً أنه يطلق ممكنات الإنسان، فهو يستفز مكونات هويتك ويتحداك في كل لحظة كي تثبت جدارتك واستحقاقك لفرصة عمل تشغلها، متقدماً على منافسيك من المواطنين الأصليين. ولأن المنفيّ خلّف وراءه كل شيء فهو يتمتع بجرأة وإقدام من لا يخشى المزيد من الفقدان. لذا تراه يخفق ويعيد المحاولة مراراً، يطرق أبواباً متعددة ومهناً متنوعة، إذ في الغرب لا وظائف ولا تعيينات جاهزة بل كفاح للوصول إلى أي فرصة عمل كريمة. لذا بوسع كل منا أن يروي الكثير من الحكايات، وقد بدأت بتدوينها لأني أعتقد -بتواضع شديد – أني تعددت في حياتي بسبب من تعدد انشغالاتي واهتماماتي الأدبية والأكاديمية والترجمية، فضلاً عن أنشطتي في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والنساء بوجه خاص، وانشغالات تمثلت في الحوار مع الآخر المختلف في مجال الأديان والثقافات، إنطلاقاً من موقفي كإنسان يؤمن بفصل الدين عن الدولة مع احترام الإختلاف. ولعلي سأترك بعضاً من شهاداتي أيضاً على وقائع عايشتها في لحظات تاريخية مهمة بحكم عملي.
وعلى الرغم من جهود الأسبان، من مستعربين كبار ومؤرخين وآثاريين قاموا بجهود حثيثة كاشفة للآثار المعمارية ولمؤلفات الأدب والفكر الإسلامي العربي في أسبانيا، فإن هذا الإرث المشترك غير مستثمر جيداً من قبل الطرفين، العربي والأسباني، من أجل خلق قاعدة مشتركة تقرب ما بين الثقافتين لنشر مزيد من الفهم ووعي المصالح المشتركة. ولا ننسى هنا أن حقب هيمنة الكنيسة وعهد الديكتاتورية الفرانكوية (1939- 1975) وإقصاء الآخر المختلف معها – قبل التحول إلى الديمقراطية والقبول بالتنوع الثقافي والديني- قد كرّست قطيعة معرفية بالآخر (المسلم) جعلت الأسبان أنفسهم يجهلون هذا التاريخ الممتد لثمانية قرون.
ليس لي أولاد، لكن طلبتي وأحفاد العائلة يشعرونني بمسؤولية أخلاقية إزاءهم فهم الجيل القادم من أبنائنا الذي سيصحح أخطاءنا ويعيد وجه الوطن الإنساني الناصع الذي نحلم به جميعاً.
العديد ممن هاجروا أوطانهم تمكنوا من تقديم انتاج إبداعي في كافة مجالات الحياة
المنفى يمنحنا الفرصة لإعادة اكتشاف الذات والآخر، والأهم إعادة اكتشاف الهوية والوطن والمسلمات والبديهيات الأولى، من خلال عملية زعزعة الثوابت المتحجرة. وأحسب أن الكثير من المثقفين العراقيين استفادوا من هذا المختبر الإنساني الهائل واجتهدوا في التفاعل مع التجارب الانسانية العالمية، كل حسب تخصصه، ونشروا الكثير من المؤلفات الفكرية والأدبية وأبدعوا نتاجات فنية وموسيقية ما يستحقون عليه الإعجاب والإشادة والثناء.
وعلى الرغم من وجود (غيتوهات) المغتربين العراقيين والعرب، لا بد لي من القول إن من بينهم من نجح في العيش بين ثقافتين ولغتين وبرز وتفوق. ولعل من بين أكثر من أبدع في المنافي هم العراقيون. لا أقولها انحيازاً بل توصيفاً لواقع يعرفه ويقرّ به الأجانب والمثقفون العرب أنفسهم. لقد أبدعوا في شتى المجالات ونافسوا الآخرين بعصامية جديرة بالاحترام والاعجاب.
هنا في أسبانيا لدينا عدد، ليس بالكبير ولكنه مهم، من الشخصيات الأدبية والأكاديمية العراقية -والعربية أيضاً- اللامعة في المجالين العلمي والإنساني. لدينا أسماء مهمة لكتاب وأدباء (شعراء وروائيون وقاصون ومسرحيون) وصحفيين وفنانين (من رسامين وخزافين وسينمائيين..) لدينا مبدعون في كل المجالات الأدبية والعلمية أيضاً (أطباء ومهندسون ومعماريون…) وحيثما يمر العراقي المبدع يترك بصمة واضحة يشير إليها الآخرون.
لقد تفاوتت ظروف هؤلاء المبدعين في المنافي والمغتربات، فمنهم من لقي الدعم من البيئة الحاضنة، ومنهم من عانى وكدح ليواصل العمل والإبداع. ومن حصل على اللجوء السياسي أو الإنساني حظي بفرصة عظيمة للتفرغ للإبداع في الأدب والفن والموسيقى والدراسة الأكاديمية. وهنا أشير إلى من لجأوا إلى بلدان أوروبا الغربية والدول الاسكندنافية على سبيل المثال. أما من اختار البقاء مهاجراً فكان نصيبه من العناء أكبر بكثير، خاصة مع غياب المعونات الاجتماعية والثقافية في بلد كأسبانيا.
ويبقى المنفى فرصة لإعادة اكتشاف الذات أو للإنتحار، وهذا الأخير لا يعني بالضرورة أن يكون مادياً بل معنوياً، فلكم ضاعت حيوات لشباب وشابات في الغربة. حقاً أن الأمر مرهون بالظروف المحيطة التي قد تساعد المرء أو تحبطه، ولكن قبل هذا وذاك فهو منوط بشخصية المرء وكل حمولاته المعرفية والثقافية والاجتماعية والبيئية.
كل مكان في هذه البلاد، أي شبه الجزيرة الايبيرية مليء بما تركته الحضارة الإسلامية و حتى القادمين من الشرق كالفينيقيين والموريين الأوائل آثار الحضارة العربية الإسلامية ماثلة حتى اليوم في تفاصيل كثيرة من حياة المجتمع الأسباني ولا تقتصر فقط على الصروح والآثار المعمارية المتمثلة في قصر الحمراء وجامع قرطبة وعشرات الأمكنة التاريخية. فثمة أسماء المدن والقرى والأنهار العربية التي تصادفك حيثما تنقلت، والكلمات العربية في اللغة الأسبانية التي تربو على 4000 كلمة مستخدمة حتى اليوم، وعدد كبير من الاستخدامات اللغوية والأمثال المستمدة من التراث العربي، وحتى ملامح الوجوه في بعض المناطق والألقاب والعادات وأساليب الطبخ والحلوى.
كل هذا يجعل لأسبانيا خصوصية تميزها عن باقي البلدان الأوربية. إلا أن موضوع الأندلس وتاريخها وإرثها الإنساني ووعي ما تعنيه تاريخاً وحاضراً ما زال مجهولاً لدى عموم الإسبان، ويكاد يقتصر على المستعربين والأكاديميين وقلة من المثقفين وعشاق الثقافة العربية والإسلامية.
وعلى الرغم من جهود الأسبان، من مستعربين كبار ومؤرخين وآثاريين قاموا بجهود حثيثة كاشفة للآثار المعمارية ولمؤلفات الأدب والفكر الإسلامي العربي في أسبانيا، فإن هذا الإرث المشترك غير مستثمر جيداً من قبل الطرفين، العربي والأسباني، من أجل خلق قاعدة مشتركة تقرب ما بين الثقافتين لنشر مزيد من الفهم ووعي المصالح المشتركة. ولا ننسى هنا أن حقب هيمنة الكنيسة وعهد الديكتاتورية الفرانكوية (1939- 1975) وإقصاء الآخر المختلف معها – قبل التحول إلى الديمقراطية والقبول بالتنوع الثقافي والديني- قد كرّست قطيعة معرفية بالآخر (المسلم) جعلت الأسبان أنفسهم يجهلون هذا التاريخ الممتد لثمانية قرون.
التواصل مع هموم الوطن هاجس المهاجر الأبدي وقد كنت دوما تابعين اخبار الوطن وما يحدث هناك حدثينا عن آمالك وتنبؤات المستقبلية كشاعرة
المنفى أيضاً يتيح لنا فرصة استعادة الوطن الذي يصغر أحياناً ونحن فيه حتى لا نعود نراه من شدة قسوته، أو على الأصح، قسوة حكامه ورثاثتهم. وهكذا يستعيد الوطن حجمه الموضوعي، فتصبح الهوية والجذور مسألة كينونة وصيرورة وانتماء متجدد، وقد تأملت فكرة الوطن والذات والآخر في أعوام الغربة الطويلة هذه. وكل ما أكتبه من شعر ونثر أنما هو تعبيرات أدبية أسعى من خلالها إلى تحرير هواجسي وقلقي وتفاعلي مع الحياة، هناك وهنا، بشؤونها الكبيرة وتفاصيلها الصغيرة معاً. مساحة الشخصي في كتاباتي صغيرة، مقارنة بانشغالي العميق بالهم العام الإنساني وأوضاع العراق والتدهور الكارثي الذي أصابه.
في الماضي كان الوطن والمواطنون مكبلون بالديكتاتورية، لكن كان لنا متسع للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، وبقية شعوب العالم. الآن تكالبت علينا الاحتلالات من كل الجهات وبات الخونة كثر والمرتزقة أكثر، حتى لم يعد في وسعنا التضامن حتى مع بعضنا، كأبناء شعب واحد. كل هذا يقلقني، ويجعلني أكثر اشتراطاً على نفسي ووضوحاً في موقفي. لذا تجد أن نصوصي الشعرية حتى من قبل ثورة تشرين كانت مكرسة لهذا الهدف. والآن، بعد أن انطلقت الثورة وأريقت دماء الشهداء لن تكون هناك عودة أبداً إلى الوراء، إذ لا بديل عن الحرية والكرامة الإنسانية لشعب هو من أعرق شعوب الأرض، شعب علم البشرية الكثير وما زال أمامه أن يسهم في ترقية الحضارة الإنسانية.
لا يفوتني القول أني أميل إلى السلم بطبيعتي وأكره العنف بكل أشكاله، من اللفظي حتى الحربي. لذا دعمت احتجاجات المتظاهرين السلميين في أنحاء العراق بكتاباتي وسأواصل. وقد كتبت نصوصاً هجائية للحروب التي دمرت مجتمعنا العراقي وأفنت خيرة شبابه، ودفنت أحلامه جيلاً بعد جيل، ونشرتها في ديواني الشعري “حرب تتعرى أمام نافذتي”.
أما عن تنبؤاتي المستقبلية، إنسانة قبل أن أكون شاعرةً، فلا أملك منها شيئاً سوى يقيني بتوق الإنسان النازع نحو الحرية والعدالة، وإرادته التي كانت على مسار التاريخ تخرجه من حالة النكوص والتردي وتعيده إلى عالم القيم الخالدة للخير والحق والجمال، بمعناه الأفلاطوني الأزلي.
أخيراً، أشكرك، دكتور توفيق، على إتاحة الفرصة لي للتفكير مع القراء بصوت عالٍ، وهي من مرات قليلة أفعل فيها هذا، واسمح لي أن اختتم هذا الحديث بقولي:
إني ما زلتُ في المنفى، أعني ما زلت أحيا كل لحظة في الوطن.
وانا بدوري أردد قول شاعرتنا واشكرها على اتاحة هذه الفرصة لي ولقرائها للاستمتاع بآرائها، افكارها وشعرها، تلك البوابة الكبيرة في الحياة.