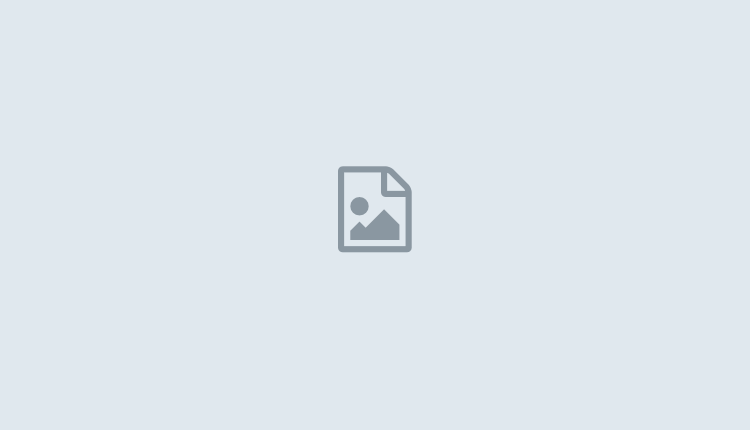ستيف فريزر -صحفي و مؤرخ أمريكي (عن مجلة Jacobian)
ترجمة كفاح عادل
التهديد للديمقراطية الحقيقية التي تعزز الرفاهة المادية والمساواة والتضامن الاجتماعي هو أعمق من دونالد ترامب لأنه يأتي من الرأسمالية و التي لا يمكنها أبدًا أن تتصالح مع الديمقراطية.
“لدينا ثمانية أشهر لإنقاذ جمهوريتنا”، هكذا حذرت إليزابيث تشيني، النائبة عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي, وهو أمر جدير بالملاحظة بالفعل! تشيني هي أبنة نائب الرئيس الأقل شعبية في تاريخ أميركا وقبل هذا التصريح, كان هناك طيف واسع من الرأي العام قد شكل إجماعا حول هذا الموضوع,من منشورات ليبرالية مثل (نيويورك تايمز، ونيويورك ريفيو أوف بوكس، ونيو ريبابليك) إلى منشورات أكثر ميلا إلى اليسار مثل (ذا نيشن). وبطبيعة الحال، فأن الحزب الديمقراطي بأكمله دق ناقوس الخطر، من الرئيس جو بايدن إلى السيناتور اليساري بيرني ساندرز، ومن الرئيس السابق باراك أوباما إلى رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي. وأعلن أعلى المسؤولين في مؤسسة الأمن القومي الأمريكي، وهم أشخاص لا يُنظَر إليهم عادة باعتبارهم مدافعين عن الديمقراطية ــ بل ويرتبطون بشكل أكثر انتظاما بالجهود السرية لتقويضها في جميع أنحاء العالم ــ فجأة أن “التهديد للديمقراطية” لن يمر. وانضمت وسائل الإعلام الإلكترونية، سواء الاجتماعية أو القديمة، إلى الجوقة بل حتى تم تحويل الحرب الأهلية الوشيكة إلى فيلم سينمائي.
لقد أصبح الاعتقاد بوجود “تهديد وجودي للديمقراطية” قناعة راسخة في أوساط عديدة. من غير الواضح ما إذا كان هذا التهديد سيختفي إذا هُزم دونالد ترامب أم لا؛ لكنني أظن أن معظم الناس يتفقون على أن التهديد سيستمر وربما يلقي بظلاله على مستقبل السياسة الأمريكية.
إن الافتراضات المسبقة تعطي ثقلًا لهذا الشبح: أن الأمة الآن ديمقراطية، وإن كانت غير كاملة، ولكنها قد تتوقف عن كونها كذلك إذا انتُخب ترامب؛ وأن الدستور هو الحصن الأكثر قيمة للديمقراطية ولكنه يتعرض للهجوم؛ وأن الديمقراطية والليبرالية متصلتان ببعضهما البعض؛ وأن اسم “التهديد الوجودي” هو الفاشية أو نوع من الهجين بين الفاشية الاستبدادية أو الاستبداد الفاشي (أو على حد تعبير الرئيس جو بايدن، “شبه الفاشية”)؛ وأنه من الضروري لجميع أولئك الذين يريدون إخماد التهديد قبل أن يسبب ضررًا مميتًا أن يشكلوا أوسع جبهة موحدة مناهضة للفاشية ممكنة.
أين هي الديمقراطية؟
حق الأقتراع للمواطن الأمريكي موجود (و أن كان يتعرض للخطر بين الحين و الآخر) و لكنه ليس الشكل الوحيد للديمقراطية بل في بعض الأحيان تصبح عائق أمام أي شكل من أشكال المشاركة الجماهيرية الأخرى (كون الأنتخابات هي الشكل الوحيد للديمقراطية). ناهيك عن أن النظام الأنتخابي الأمريكي يعاني من خلل في تقسيم الدوائر الانتخابية، والحاجة المتكررة إلى أغلبية ساحقة، وعرقلة التصويت، ونتائج التصويت بالأغلبية المطلقة، وغير ذلك من السمات التي تعطل الديمقراطية.
ولكن قِلة هم الذين يعتقدون بجدية أن الشعب فعليا يحكم. فالمال يحكم، سواء بشكل مباشر أو من خلال شبكات سماسرة السلطة والمشرعين. وهذا هو الشعور السائد حول كيفية عمل النظام.
ولكن لماذا تعتبر الأغلبية الحكومة فاسدة (وهو رقم ارتفع من 59% في عام 2006 إلى 79% في عام 2013 ــ تقريبا في سنوات أوباما ــ ولا يزال غير بعيد عن هذا المستوى اليوم).عاما بعد عام، تسجل استطلاعات الرأي نفس الأغلبية لصالح كل شيء من الرعاية الصحية الشاملة إلى مجانية التعليم، ومن التعامل الجاد مع تغير المناخ إلى إجازة الأمومة المدفوعة الأجر. ولكن لا يحدث إلا القليل، أو في أغلب الأحيان لا يحدث شيء على الإطلاق.
لماذا؟ لأن المجتمع الذي يرتكز على الفردية، والذي يعامل مواطنيه باعتبارهم مجاميع من المستثمرين و أصحاب مشاريع صغيرة, لا يخلق البيئة الملائمة للديمقراطية. ففي نهاية المطاف، تفترض الديمقراطية شكل من أشكال التواصل المجتمعي مع الآخرين.
كانت الديمقراطية مهددة من وقت طويل قبل أن يصبح دونالد ترامب سياسياً. ويظل الشعور بالعجز قائماً, فالأحزاب السياسية التقليدية، التي كانت في يوم من الأيام تعطي أهتماما للمطالب الشعبية، و أن كان بشكل محدود، أصبحت الآن بلا محتوى أو فعالية. والحركات الجماهيرية، وخاصة الحركات العمالية، ميتة أو ضعيفة، و كما هو الحال مع حركة “حياة السود مهمة” أو غيرها من الحركات القائمة على الهوية، فأنها لا تهدد الأسس الاقتصادية والسياسية للنظام القائم.
إن مسائل الحرب والسلام، وكيفية توزيع موارد البلاد، وما إذا كان تركز الثروة يقوض المجتمع، وغيرها من القضايا الحيوية ، يتم صياغتها وحلها بأضيق قدر ممكن من المداولات الشعبية (أو تُترك دون صياغة وبالتالي تُترك دون حل). إن معظم الإنفاق المالي، والضمان الاجتماعي، والسياسات الاجتماعية يجري الأتفاق عليها خارج نطاق المداولات الشعبية. تفضل النخب الحاكمة، على حد تعبير أحد محافظي البنوك المركزية الألمانية، “الاستفتاء الدائم للأسواق العالمية”. ووافقت المستشارة الألمانية المنتخبة والمُعاد انتخابها ديمقراطيا أنجيلا ميركل على ذلك، داعية إلى “ديمقراطية تتوافق مع الأسواق”. بأختصار هي عبارة عن ديمقراطية بدون الجماهير، وسياسة بدون دولة!
لقد أصبحت السياسة مجرد تمرين في علم الإدارة من قِبَل أولئك الذين يتمتعون بالمؤهلات المناسبة. و قد تخلت النخب منذ فترة طويلة عن قناعاتها الإيديولوجية الإنسانية. وبدلاً من ذلك، سعت إلى منطق عملي يمنح الأولوية للإدارة الخبيرة والتعديلات الفنية للحفاظ على استمرار عمل المؤسسات، أو على الأقل منعها من الانهيار بالكامل. وتشرف المستويات العليا من الطبقة الإدارية المهنية وتدير وتنفذ العمل الفكري. ومن المفترض أن يوافق الجميع، وهم غير مطلعين على الحد الأدنى من المعلومات و بالتالي لا يمكنهم تكوين أي رأي جوهري.
حتى أعرق الديمقراطيات تخلت عن تراثها الديمقراط, إن أغلب دول أوروبا، على سبيل المثال، تديرها الآن مجموعة ثلاثية تتألف من صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، ومجموعة اليورو، وهي هيئة غير رسمية من وزراء المالية، والتي وصفها أحد الكتاب بأنها “وحش نيوليبرالي”. لقد أصبحت الجدارة شكلاً خبيثاً من أشكال معاداة الديمقراطية تحت ستار الديمقراطية.
وهذا ليس سراً. فالنخب السياسية والفكرية، الليبرالية بلا شك، لا تخجل من الاعتراف بأن ما يبقيها مستيقظةً طوال الليل هو التهديد الذي تشكله الديمقراطية بقدر ما هو التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية. ويعرب مؤلفو كتاب “عندما تموت الديمقراطية” عن أسفهم لاختفاء “المصدات” التي تحمي الديمقراطية المفرطة. إنهم يقصدون كل تلك الآليات ــ والمناورات والصفقات التي تتم خلف الكواليس من قِبَل سماسرة السلطة ــ التي نجحت ذات يوم في استئصال “المتطرفين” مثل ترامب و لكنها فشلت اليوم (وبالمناسبة، على وجه التحديد ذلك النوع من المناورات البارعة التي جرت خلف الكواليس والتي أدت إلى اختيار كامالا هاريس كرئيسة قادمة ربما).
و من هذا المنطلق، تتحمل النخب مسؤولية التعامل مع تهديد الديماغوجيين الشعبويين الذين يستهدفون المؤسسة بتهور، والذين يذهبون إلى حد اتهام أصحاب السلطة بالتجاوزات ضد الديمقراطية. والمطلوب الآن هو البحث عن “حراس الديمقراطية”. لقد عبر فريد زكريا (مقدم برامج في قناة سي أن أن)، الذي اشتهر، من بين أمور أخرى، بإطلاق أجراس التحذير حول ظهور ما يسميه ب “الديمقراطية غير الليبرالية”، عن الأمر بصراحة: “إن ما نحتاج إليه في السياسة اليوم هو ليس المزيد من الديمقراطية بل أقل”.
ولكن الديمقراطية الأميركية، على الرغم من عيوبها، لا تزال تستحق الحماية. فهي تضمن الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها. فالجميع يتمتعون، أو من المفترض أن يتمتعوا، بالمعاملة المتساوية أمام القانون. وعلى مدى حياتها، عملت الديمقراطية في أميركا على توسيع هذه الحقوق لتشمل كل المواطنين.
ولكن هل هذا صحيح؟
هل الديمقراطية غير دستورية؟
بفضل أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير/كانون الثاني 2020، وصلت سمعة الدستور باعتباره حجر الزاوية للإنجاز الديمقراطي إلى مستويات جديدة. وبالنسبة للكثيرين، لا يوجد دليل أكثر إقناعا على “التهديد الوشيك للديمقراطية” من محاولة عرقلة الانتقال السلمي للسلطة قبل ما يقرب من أربع سنوات.علما أن الدستور قد صمم كوسيلة لمراقبة وحتى قمع ما كان يخشى مبتكروه أن يصبح فائضا من الديمقراطية، أو ما أشار إليه العديد من الآباء المؤسسين باسم “الحكم الغوغائي”. و في ذلك الوقت، كانت البلاد تعج بمثل هذه الدوافع الديمقراطية، بل وحتى الدوافع التمردية بين الحين والآخر: ثورات الضرائب، ووقف سداد الديون وإلغائها، ، ووقف عمليات استعادة الأراضي من قِبَل البنوك و غيرها.
كان كل هذا مزعجاً للغاية للنخب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أميركا ما بعد الثورة. وبدا الأمر وكأنه يتطلب شيئاً جذرياً. فالخمسة والخمسون رجلاً الذين اجتمعوا في فيلادلفيا، والذين أجروا مداولاتهم في سرية، وأغلقوا أبواب ونوافذ الغرفة الشرقية في مجلس ولاية بنسلفانيا على الرغم من حرارة شهر يوليو الخانقة حتى لا يتمكن أحد من التنصت على إجراءاتهم، كانوا في نهاية المطاف يفكرون في نوع من الانقلاب. ولم يكن هؤلاء قد أُرسِلوا إلى فيلادلفيا لصياغة دستور جديد، بل لتعديل مواد الاتحاد. ولكنهم كانوا في العموم رجالاً من ذوي النسب الاجتماعي والتعليم والممتلكات، وكانوا يتوقعون احترام حقوقهم في الملكية، وأن يذعن من هم أدنى منهم في المجتمع لحقهم في الحكم باعتبارهم أشخاصاً من ذوي التربية والحكم النزيه.
ولم يكن ترويض الديمقراطية هو السبب الوحيد وراء تصور الدستور. ولم تتعامل أحكامه العديدة حصرياً أو على الإطلاق مع هذه المعضلة. ومع ذلك، فقد عملت الكثير منها على فتح المجال بين الطبقات الحاكمة والجماهير. مع ذلك فأن الدستور الأمريكي ليس خارطة عمل للديمقراطية, بل إنه في واقع الأمر عبارة عن تصميم أساسي الغرض منها إقامة نظام سياسي ليبرالي. ولكن مع مرور الوقت، وخاصة في الآونة الأخيرة، تلاشى التمييز بين الليبرالية والديمقراطية. فالولايات المتحدة تصف نفسها بأنها ديمقراطية ليبرالية، مما يعني ضمناً أن المجتمع الليبرالي والمجتمع الديمقراطي هما نفس الشئ تقريباً. وتزعم الحكومة، بغض النظر عمن يديرها، أنها تدعم الديمقراطية الليبرالية في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنها عملت على مدى أجيال على تقويض الديمقراطية بشكل منهجي كلما وأينما استنتجت أن مصالحها المادية والاستراتيجية على المحك.
ومع ذلك، فإن التعامل مع الدستور باعتباره خلاصة الديمقراطية، وتحديده باعتباره الهدف الرئيسي لأولئك الذين يهددون الديمقراطية، يؤدي إلى استمرار الخلط بين الليبرالية والديمقراطية.
ولكن الليبرالية والديمقراطية لم تتفقا إلا بين الحين والآخر، وكانتا في كثير من الأحيان على خلاف. وليس فقط في العالم الجديد، بل وفي أوروبا أيضاً أثناء عصر الثورة فقد تعاونت الطبقات البرجوازية والعامة وواجهت بعضها بعضاً في التنافس ضد النظام القديم.
إن من الخطأ الفادح أن نقارن بين المداولات السرية في فيلادلفيا ومذبحة العمال الباريسيين التي ارتكبتها الجمهورية الثانية خلال يونيو/حزيران من عام 1848. ولكن النقطة تظل قائمة: فالإصلاح الليبرالي ــ نهاية الملكية، والدستور، وحق الاقتراع، وما إلى ذلك ــ كان في كثير من الأحيان مدفوعاً إلى الأمام من قِبَل الطبقات الدنيا، وكان يثير القلق، وأحياناً المعارضة العدوانية، من قِبَل رؤسائهم الاجتماعيين. ومن وجهة نظر الإصلاحيين الليبراليين، قد لا يُسمح للثورة الديمقراطية بالذهاب إلى أبعد من هذا الحد. إن الثورات التي تهدف إلى الفوز بالحرية والحقوق السياسية والديمقراطية البرلمانية والمساواة أمام القانون كثيراً ما تحاصرها أفكار ثانية وإعفاءات، مثل ما يتعلق بالأقليات الدينية و العرقية والنساء والعبيد السابقين والمعدمين والفقراء عموماً.
على سبيل المثال، أعلنت الثورة الفرنسية في عام 1793 حق الاقتراع العام، ولكن سرعان ما سحبت هذا الحق بعد ذلك. وتكررت هذه الديناميكية في فرنسا وألمانيا في أعقاب ثورات عام 1848 ومرة أخرى بعد اضطرابات مماثلة في إيطاليا وبريطانيا العظمى. وحتى ذلك المثال للفلسفة الليبرالية، جون ستيوارت ميل، كان قلقاً بشأن عدم التوافق بين الرأسمالية والديمقراطية، فأوصى بحق الاقتراع التعددي ــ المزيد من الأصوات للتجار ورجال الأعمال والمصرفيين والمهنيين ــ لإحباط شهية العامة. وكانت آخر دولة في الغرب تنشئ هذا المعيار للديمقراطية بالطبع الولايات المتحدة.
ولكن عندما تجاوزت هذه التمردات حدود الساحة السياسية، عندما أثارت ما كان يُعرف لفترة طويلة بـ “المسألة الاجتماعية” أو “مسألة العمل”، عندما استهدفت التسلسل الهرمي الاقتصادي والاجتماعي الذي حدد هذه المجتمعات ـ وهو ما فعلته حتماً ـ أعلنت النخب الليبرالية، وهي تحمل السلاح في أيديها، أن هذه الأمور أصبحت خارج الحدود، ومحظورة. وهنا كان لابد أن تتوقف الديمقراطية تماماً؛ وهنا أصبحت الديمقراطية في نظر الليبراليين “حكم الغوغاء”. وكان إدموند بيرك محقاً حين أشار إلى أن “الديمقراطيين الليبراليين ، يعاملون الجزء الأكثر فقراً من المجتمع بأكبر قدر من الازدراء، وفي الوقت نفسه يتظاهرون بجعلهم ذخرا لسلطتهم”.
وكم بدت الأمور مختلفة على الضفة الأخرى للأطلسي. فعندما ذبح جيش الجمهورية الثالثة الليبرالية كومونة باريس، نظر أحد الناجين من حمام الدم إلى الوراء ليقول: “إن جمهورية أحلامنا ليست بالتأكيد الجمهورية التي لدينا. لقد أردناها ديمقراطية واجتماعية وعالمية وليست جمهورية للأثرياء فقط!”. ولعل الأمر الأكثر دلالة، عند النظر في من يهدد من، هو ذكرى أخرى لأحد أعضاء الكومونة: “لن تتحرر البروليتاريا حقًا ما لم تتخلص من الجمهورية ــ الشكل الأخير من أشكال الحكومات الاستبدادية وأقلها شرًا”. وقد ظهرت حالات مماثلة مرارًا وتكرارًا خلال العصر الذهبي المفرط العنف في أمريكا عندما شعرت الليبرالية بأنها مضطرة إلى إظهار جانبها المظلم.
ولا تزال الأسئلة الأساسية قائمة. إذا كان هناك “تهديداً للديمقراطية” اليوم، فهل يمكن الدفاع عن الديمقراطية دون مواجهة الرأسمالية؟ إذا كانت الجبهة المتحدة ضد هذا التهديد بقيادة النخب الليبرالية، كما هي الحال اليوم بالتأكيد، فما هو مصير الديمقراطية، أو على الأقل ذلك النوع من الديمقراطية التي أزعجت جيمس ماديسون وجون ستيوارت ميل وحلم بها أولئك الذين ماتوا في الكومونة؟ إذا كان هناك “تهديداً للديمقراطية”، فهل يجب محاسبة هذه النخب الليبرالية؟ وأخيرًا، ما هي طبيعة هذا التهديد؟ هل هو فاشي؟ هل مناهضة الفاشية هي القاسم المشترك لخلاصنا السياسي؟
الفاشية ومناهضة الفاشية
لقد فقدت الليبرالية قبضتها قبل سنوات من وصول ترامب إلى المشهد. وكان الانهيار الوشيك للنظام المالي العالمي في عام 2008 بمثابة علامة على انحدار أطول أمدًا، والذي استمر بعد إنقاذ البنوك الأمريكية من الأنهيار و ما رافقه من أنهيار للصناعة. و هنا يمكن مقارنة متوسط العمر المتوقع للربع الأفقر من سكان الولايات الأمريكية الصناعية و الذي أنخفض بمقدار أعلى مقارنة مع الربع الأدنى من جميع الولايات الأخرى؛ ولا يوجد مقياس أساسي للتراجع أكثر من ذلك و الذي ترافق مع استهلاك أعلى للمخدرات, بالأضافة الى أنخفاض حصة الفرد الأمريكي من الدخل القومي بنسبة 7.5% للفترة من 1980 إلى 2016.
كانت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بمثابة كارثة بالنسبة للملايين من أبناء الطبقة العاملة. وفي الخارج، تشير الدراسات إلى أن “أسواق العمل المعرضة للمنافسة من قبل الواردات الصينية شهدت المزيد من إغلاق المصانع وانخفاض في العمالة في قطاع التصنيع” (حوالي مليون وظيفة في عقد من الزمان، 1999-2011) ومليوني وظيفة أخرى أو أكثر. وانخفضت نسب العمالة إلى نسبة السكان. وانخفضت أرباح العمال ذوي الأجور المنخفضة. ولم تكن هناك أي علامة على التعافي. وبعد كل هذا جاء الركود العظيم.
اختفى الحراك الاجتماعي، وهو أقدس شعارات الليبرالية، بالنسبة لملايين الناس. لقد لخص خبير الإدارة بيتر دراكر الأمر بقوله: “لم ترتفع أي طبقة في التاريخ بنفس السرعة التي صعد بها العمال ذوي الياقات الزرقاء، ولم تسقط أي طبقة بنفس السرعة. كل هذا في أقل من قرن من الزمان”. من ناحية أخرى، تضخمت الموارد عند ال 1% الأعلى دخلاً بشكل جنوني.
أن كل هذا حدث في ظل الليبرالية و الديمقراطية الليبرالية. والأمر الأكثر أهمية هو أنها مهدت الطريق لحركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” MAGA الداعمة لحملة المرشح الجمهوري ترامب فقد أصبح تدهور الليبرالية التربة الخصبة التي تغذي سياسة الاستياء. لم يكن ترامب أول من اغتنم الفرصة، لكنه فعل ذلك بحماس خاص. خلال حملته الانتخابية في عام 2016، هاجم اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الفاشلة التي اقترحها أوباما، وهاجم شركة أمازون لأنها “تفلت من العقاب على تهربها من الضريبة” ـ وهاجم شركات أمريكية لنقلها معاملها إلى المكسيك. وكان آخر إعلان له في حملة عام 2016 يدور حول التشابك بين بنك الاحتياطي الفيدرالي و وول ستريت لتشكيل “هيكل قوة عالمي مسؤول عن القرارات الاقتصادية التي سرقت الطبقة العاملة لدينا، وحرمت بلادنا من ثرواتها، ووضعت الأموال في جيوب حفنة من الشركات الكبرى والكيانات السياسية”. و تجدر الإشارة إلى أن هذا الخطاب كان خامدا أثناء فترة ولاية ترامب الفعلية و لم يفعل اي شئ مما وعد، يمكن قول الشيء نفسه عن عقود من الوعود الفارغة من قبل الحزب الديمقراطي.
إن مقاومة الديمقراطية الليبرالية قد تسلك طرقاً مختلفة. فقد فتح بيرني ساندرز طريقاً (أغلقته النخب الليبرالية التي تقود الجبهة المتحدة ضد “التهديد للديمقراطية”). ولن يشكك أحد في حسن النية الديمقراطية لظاهرة ساندرز. ولكن ماذا عن حركة “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”؟ لقد فتحت هذه الحركة طريقاً آخر. وهي أيضاً نتيجة لفشل الديمقراطية اليبرالية و التي أصبحت عمليا معادية للديمقراطية، وتدين أي تمرد يحدث خارج الحدود باعتباره “ديمقراطية غير ليبرالية”، وترى فيه نوعاً من الشعبوية الضارة.
إذا كان المقصود من الديمقراطية الإشارة إلى التعبير الفعال عن المشاعر الشعبية التي لا تستطيع أن تجد صوتاً من خلال القيود الضيقة للديمقراطية الليبرالية، فإن ساندرز وحركة “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” مؤهلان لذلك. وهذا هو السبب وراء تذبذب العديد من الناخبين بين ترامب وبيرني في السنوات التي سبقت هزيمة الأخير في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2020.
ومع ذلك، فإن حركة “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” هي حركة مشوهة لدرجة أنه يجعل من الصعب التعرف عليها كشكل من أشكال التمرد الديمقراطي. وتسري السموم في مجرى دمها: العداوات العنصرية والقومية، والتفاخر الذكوري والدوافع المعادية للنساء، والتعصب الديني، والرجعية الأبوية، والحنين المرير إلى ماض عاطفي لم يكن موجودًا أبدًا، والتملق القومي، وما هو أسوأ من ذلك.
يسمي البعض هذا التوجه فاشية. وهناك ما يكفي من الخطاب التهديدي والفاسد الصادر عن حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” لجعل هذا الأمر معقولاً. الواقع أن هناك حججاً تزعم أن الخزين الهائل للعنصرية والرجعية والقمع الذي يشكل الوجه الآخرلأمريكا تراكم على مر القرون حتى بلغ الكتلة الحرجة. و الفاشية بطبيعتها متفجرة. ولكن إذا ما حللناها على أنها فقط كتلة من العنصرية والرجعية والقمع ــ أو بكلمة واحدة، الشر المطلق ــ فإن هذا يحرمها من خصوصيتها التاريخية. ولكن إذا ما اختزلنا هذه الظاهرة الاجتماعية إلى مجرد شتائم، فإنها تصبح غامضة، وغير واضحة، بحيث يمكن استنكارها، ولكن من غير الممكن أستثمار السخط و الشكوى منها كأساس للتحرك ضدها (أي الفاشية). وهذا التشخيص بالضرورة يعفي أصحاب السلطة من أي مسؤولية عما ارتكبوه و كونهم السبب في صعود هذه الحركات و بالتالي تصبح “الجبهة المتحدة” التي تقودها نفس هذه السلطة و كأنها مجموعة من الأتقياء. و هنا تبرزالأسئلة المزعجة حول الإخفاقات والجرائم التي ارتكبتها الديمقراطية الليبرالية ؛ وهذا يشمل تمكين الإبادة الجماعية في غزة.
ومع ذلك، أليس ترامب و”جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” فاشية؟ من المؤكد أن الفاشية موضوع جدلي.من الواضح أن ترامب ينحدر مما أسماه فيليب روث ذات يوم “المجنون الأمريكي الأصلي”. ولكن الاختلافات الحاسمة بين الفاشية التاريخية و”جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” جديرة بالملاحظة.
كان مؤسسو الفاشية رجالاً (وبعض النساء) من العدم، “أناس صغار. ولم يكن هؤلاء ورثة إمبراطوريات العقارات، ولم يكونوا حاصلين على درجات في القانون من أرقى الجامعات، أو يديرون الشركات، أو يشغلون مناصب عليا في البيروقراطيات الحكومية. الأمر الأكثر أهمية هو أن الفاشية تصورت نفسها باعتبارها حزب المستقبل، عازمة على خلق “الإنسان الجديد” والمجتمع الجديد.
وبحسب جورج موس، المؤرخ البارز للفاشية، كانت ثورة من اليمين تصورت “إعادة ترتيب المجتمع بالقوة في ضوء اليوتوبيا المتوقعة”. من ناحية أخرى، تدور حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” حول سياسة الاستعادة، والسعي إلى طريق العودة إلى المستقبل.
لقد نشأت الفاشية لصد الحركات القوية للطبقة العاملة (الاشتراكية والشيوعية على حد سواء) – “ثورة ضد ثورة” وفقا لبينيتو موسوليني. لا يوجد مثل هذا التهديد اليوم. ولا تشبه حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” المنظمات الجماهيرية التي منحت الفاشية قوتها. وكما لاحظ أنطون جاغر، فإن حركة 6 يناير (أقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي) ليس لها قوائم عضوية، وتعيش على المدونات والفيسبوك؛ لكنها لا تقارن بالكتائب الفاشية.
ترامب ثري لكنه سيئ الأخلاق، لذلك لا ينسجم مع المؤسسة الحاكمة. ولكن على الرغم من أنه يدافع عن مصالحهم، فقد شكلوا جبهة موحدة ضده. في حالة هتلر، أصبحت البرجوازية الألمانية الراقية ملتفة حوله، لأنها كانت تخشى المد البلشفي المتصاعد.على الرغم من كثرة الحديث عن عدوانية ترامب واستعراضه لعضلاته، فأن سياسته الخارجية دفاعية للغاية. كانت الفاشية إمبريالية وعدوانية منذ البداية، وسعت، بكلمة واحدة، إلى إيجاد مساحة حيوية. ومن عجيب المفارقات أن الموقف العسكري لإدارة بايدن فيما يتعلق بالصين يتماشى بشكل أكبر مع الافتراضات الإمبريالية للسياسة الخارجية الأمريكية التي استمرت لأكثر من قرن من الديمقراطية الليبرالية.
وفي الوقت نفسه، يمكن لترامب أن يندد برأس المال العابر للحدود الوطنية، مدعيًا أنه يحمي رأس المال في الوطن ضد “العولميين”. إن معارضيه “المناهضين للفاشية” يتمسكون بالاعتقاد الخيالي بأن حلف شمال الأطلسي تم إنشاؤه ويوجد لحماية الديمقراطية على الرغم من أنه تم إنشاؤه لتوسيع السيادة الإمبريالية الأمريكية، وشمل البرتغال الفاشية في عهد سالازار منذ البداية، ورحب بالمجالس العسكرية في تركيا واليونان (بصورة غير رسمية بإسبانيا في عهد فرانكو)، وخطط سراً لتقويض الحركات والأحزاب الجماهيرية اليسارية في أوروبا الغربية بعد الحرب، واليوم يحتضن البلدان ذات المطالبات الأقل وضوحًا بالديمقراطية الليبرالية، ويواصل العلاقات مع دولة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية.
في حين أن النازية لا يمكن تصورها بدون التزامها الأساسي بالتفوق العنصري، إلا أن هذا لم يكن صحيحًا في إيطاليا الفاشية، حيث لم تدخل العنصرية والكراهية العرقية الصورة حتى ثلاثينيات القرن العشرين مع المغامرة الإمبراطورية لموسوليني في إثيوبيا. ولم تكن الإيديولوجية العنصرية مكونًا من مكونات الكتائب الإسبانية في إسبانيا أو ما يعادلها في بلجيكا. إن شعار “تسميم دماء الأميركيين” مثير للفتنة و لكنه يتوافق مع تاريخ طويل من المصطلحات العنصرية البذيئة ، فإنه لا يرقى إلى مستوى الفاشية.
تكره حركة “جعل أمريكا عظيمة مجددًا” الدولة في حين جعلتها الفاشية مثالية؛ على حد تعبير الدوتشي: “كل شيء في الدولة، لا شيء خارج الدولة، لا شيء ضد الدولة”. كانت للفاشية أيديولوجية صريحة. لكن ترامب ليس لديه أي أيديولوجية (الا أذا أعتبرنا نرجسيته أيديولوجية).
الواقع أن الادعاءات حول الطبيعة الفاشية لحركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” تستند إلى حد كبير إلى سمات شخصية ترامب. وهذه السمات موجودة، ولكن لا يمكن اختزال الفاشية في اضطراب الشخصية. وعلاوة على ذلك، هناك فرق بين الرفض العميق للواقع الحالي والذي تتصدى له نخب الليبرالية الجديدة و بين وجود حركة فاشية حقيقية. وقد يكون الاثنان مرتبطين ولكنهما ليسا متطابقين.إن تحول الأول إلى الثاني يعتمد على ظهور حركة ديمقراطية حقيقية قادرة على معالجة الرعب الوجودي الذي خلفته الديمقراطية الليبرالية في أعقابها. ولا يمكن لهذه الحركة أن تنشأ ما دامت نفس النخب المسؤولة عن هذا الدمار تتولى قيادة جبهة موحدة بديلة ضد الفاشية. بل على العكس من ذلك، فإن مثل هذه الجبهة تجعل هذا الخيار باطلا وتُنقذ الدوائر الحاكمة من التوبيخ و الحساب الذي كان عليها أن تتعامل معه منذ الانهيار المالي في عام 2008 حتى هزيمة ساندرز في عام 2020.
من الواضح أن التصويت لصالح ترامب فكرة سيئة. إن الحريات الديمقراطية قد تكون معرضة للخطر إذا فاز ترامب ولابد من الدفاع عنها. ولكن التهديد الأعمق للديمقراطية الحقيقية، تلك التي تسمح بالرفاهة المادية والمساواة والتضامن الاجتماعي لمجتمعنا، يأتي من الرأسمالية التي لا يمكنها أبدا أن تتصالح مع الديمقراطية. إنها جبهة موحدة بكل تأكيد، ولكنها بقيادة أولئك الذين هم من صفوف الطبقة الحاكمة التي ولاءها الأول للسوق.