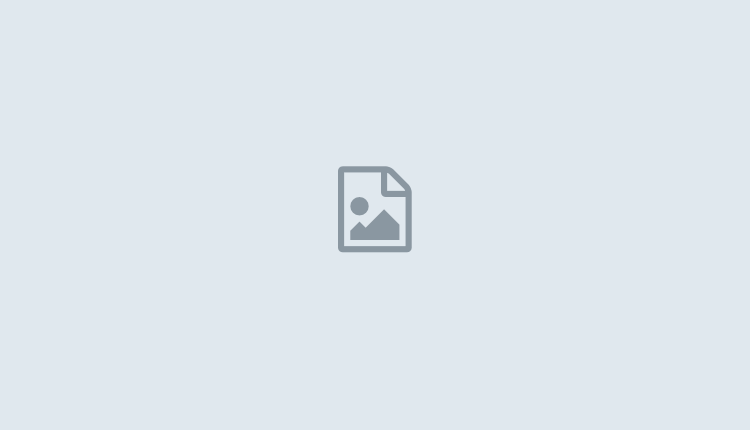شذى رحيم الصبيحي
للأبجديّةِ مفتاحٌ لا تستعصي عليه القلوب. فببضعةِ حروف وحسب، تستطيع النّفس الإنسانية أن تعبّر وتتفاعل، تعترض وتوافق، تقسو وتحنّ. وهذا ما يجعل اللغة -مهما كان أصلها- جسر تواصل واتصالٍ بين البشر. ولكن، ماذا لو وجدنا لغةً ترتقي على الحروف؟ نعم، إنها لغة قلب. تتكلّم فيها الحواس وتفاصيلها ما عدا اللسان. وقد تكون أكثر بلاغة من كلامنا المنمّق. إنها اللغة غير الكلاميّة.
لسنا بحاجةٍ لصياغةِ الجمل العميقةِ لنصف عمقَ شعورنا. فقد تكون الدمعة رسولاً للحزن. وقد يقول عناقٌ ألف قصيدةِ حبّ. وعليه، أجسادنا ليسَتْ مجرّد لحمٍ وعظم. لكنّها معجمٌ يستحقّ التأمّل والتفكير بفحواه. فقد تحمل إيماءةٌ واحدةٌ رسائلَ عديدة. فمَنْ منّا لم يعرضْ عبوس الأمّ مع رفع حاجبها أمام الضيوف تعني ألّا نكثر من تناول ضيافتهم؟ وكم ابتسامة كانت عقدَ هدنة بين متخاصميْن؟ لذا، فإنّ لغةً بدون كلماتٍ قد تكون لساناً احتياطيًّا ومسعفاً لينبئَ الكثير عن حالتنا النفسيّة ونوايانا الخفيّةِ كأنّها شيفرات سريّة. ونفكّها كأنّنا قرّاءٌ محترفين باللغات الحسيّة.
يحدّد هذا التواصل نوع العلاقة منذ بدايتها. فنظرة العين وطريقة اللمس وغيرهما تجعل الشخص الذي نظّنه غريباً كأنه كتابٌ مفتوح. وإنّ اعتمادها كطريقةٍ أساسيّة للتعبير بجانب الكلامية يمهّد لعلاقةٍ سويّة، حيث يتمتّع الشريكان بالحريّة في إطلاق العنان لمشاعرهم وإبداء ردود الفعل. وهذا ما أكّد عليه جان سيغال في كتابة لغة الذكاء العاطفي. وذلك لأنّ الطابع الروحي يبقى مسيطراً بظلاله على العلاقة. وبالتالي، يدعم استمراريتها باعتباره أنّ العاطفة وقودُ العلاقات. هذا بالإضافة إلى أنّه اللغة التي قلّما ما يساءُ فهمها كونها تحتاج إلى كلامٍ أقلّ ووضوح أكثر وجهاً وجسداً.
صفوة القول، لا يحتاجُ القلب صراخاً لينذرَ عما يعتريه من عواصف. تكفيه عينٌ حنونةٌ تفهم على معانيه المخفيّة وتقدّرها. وإذا كان السّكوت من ذهب والكلام من فضة، فلغةُ الكلام الصامت هي الألماس الذي يُنثَر في النفوس ويحيلُها ثروةً عاطفيّة.