الكاتب الذي نلتقي به اليوم ، واحد ممن غربلوا التربة المصرية بحثا عن كنوزها المدفونة. في أقصى شمال مصر ، يعيش ويكتب منذ سبع وخمسين عاما.
بدأ مسيرته مع الشعر لكن حدث أن تحول بقوة إلى السرد فأنجز ثلاثين مجموعة قصصية في ربع قرن، فاز أغلبها بجوائز مصرية وعربية.
مدينته دمياط طبعته بطابع الجدية والدقة والاستمرار ، ورغبة دائمة في تجويد أدواته، وتنويع موضوعاته، والنظر عبر زاوية غير مطروقة من زوايا الحياة.
حول المقهى إلى ندوة أدبية يومية لمناقشة النصوص الشعرية والقصصية مع وجود كوادر في الموسيقى والفن التشكيلي والمسرح . صار يأتي إلى هناك كتاب وفنانون ليلتقوا بكتاب هذا المقهى الفريد في طبيعته.
يعتقد سمير الفيل أن دوره في الحياة أن يكتب باستمرار ، دون توقف لمحاولة فك شفرة الحياة، وفهم حكمتها وقوانينها، ربما يسهم إسهاما قليلا جدا في التعبير عن الناس : آلامهم، أحلامهم، صبواتهم .
فاز بجوائز مهمة : أول جائزة في أدب الحرب عن قصة ” في البدء كانت طيبة ” 1974، جائزة الدولة التشجيعية 2016، جائزة يوسف أبورية باتحاد الكتاب 2017 ، جائزة ساويرس في القصة القصيرة 2020، وتأتي محطة مهمة في مسيرته حين حصد جائزة الملتقى للقصة العربية في دورتها السادسة بالكويت 2024.

حول مسيرته الحافلة بالأفكار والكتابة والوعي بقيمة ” الكلمة ” كان لنا معه هذا اللقاء :
حوار : عطا درغام.
* كيف يمكن للدمى أن تكون حزينة؟
ـ تخضع حياة الناس لمجموعة من الضغوط والانكسارات والمواءمات تجعل السير في الدروب أمرًا شاقًا ، ناهيك عن ظلال القهر والفقر والتدجين . كل هذا ادى إلى أن ابطال نصوصي القصصية يعيشون على الحافة الحرجة ، المسنونة ، يدحرجون أيامهم بحذر وتوجس . ولما كانت الدمى هي عنصر أكثر ارتباطًا بالطفولة، فقد انعكس عليها هذا الحزن القاسي ، المهيمن، وبالتالي فإن بكائها الخافت والمريب بات عنصرًا ظاهرًا بالرغم من سنوات الاختفاء والصمت .
* بما أنك من المشاركين في حرب أكتوبر حدثنا عن ذكرياتك فيها ،وأهم الكتابات عن حرب أكتوبر..؟
سمير الفيل: أميل إلى أن أكتب عما أعرف ، وعن تجارب حقيقة مررت بها طوال حياتي .
ـ لم أشارك في حرب اكتوبر 1973 لكنني جندت بعدها بعام كامل وتنقلت بين الكتيبة 18 مشاة ، و16 مشاة ، وعشت في خنادق سرابيوم والدفرسوار ثم انتقلت إلى تبة الشجرة بسيناء ، وهي تجربة رصدتها مبكرا في رواية ” رجال وشظايا” ؛ لأن أبطال نصوصي هم المحاربون الذين قاتلوا وتصدوا بأذرعتهم العارية وبنادقهم الخفيفة للدبابات المعادية من طراز ” باتون” وسانتريون” وهو ما ظهر في كتاباتي الأولى عن الحرب ، ولم يفطن النقاد لكوني كنت خارج التشكيلات العسكرية وقت وقوع الحرب لكنني فيما بعد بأشهر قليلة رحت أدون كل ما حدث في مسرح العمليات ، وحصلت أعمالي على جوائز القوات المسلحة الأولى، ومنها قصص :” في البدء كانت طيبة ” ، ” أيام الزهو الرمادي ” ، ” الخوذة وعصا ” ، ” أحزان الولد شندي ” ، وهكذا.
* رغم بدايتك الشعرية .لماذا اتجهت إلي السرد..؟
ـ بدأت كتابة الشعر فعلًا في عمر صغير نسبيًا ـ 17 عاما ـ وكنت واحدًا ممن يلقون قصائدهم في المقاهي والقرى أبان حرب الاستنزاف ( 1969 ـ 1970 ) وحين أصدرت ديواني ” الخيول” 1982 ، تحول فيما بعد إلى عرض مسرحي بعنوان ” غنوة للكاكي ” من إعداد محمد الشربيني ، وإخراج شوقي بكر.
التقط النقاد خيطًا رفيعًا ، لامعًا ، هو وجود نبرة السرد في قصائدي ولم أهتم بجمع قصصي المتناثرة في الصحف والمجلات إلا بعد سنوات من كتابة السرد ومع أول مجموعاتي القصصية ” خوذة ونورس وحيد” 2001 حصلت على جائزة المجلس الأعلى للثقافة في السنة التالية ، أي 2002 وفكرة تحولي من فضاء الشعر الواسع إلى واقعية السرد حدث بدون تخطيط أو ترتيب . انظر للمسألة بعد مرور 24 عاما فأجد أنها كانت خطوة موفقة فقد حدث التحول بشكل تلقائي وحاسم ومن وقتها صدر لي حتى الآن ثلاثون مجموعة قصصية كان أحدثها ” هيا بنا إلى المناخوليا ” عن دار غراب للنشر والتوزيع 2024.
* متي كانت بدايتك الأدبية؟ ومن الذي قدمك إلي الساحة الأدبية..؟
ـ ستدهش حين تعلم أن ” شخبطاتي ” الأولى جاءت في الصف الرابع الابتدائي فقد جمعنا في كراسات مدرسية ما ظنناه ، وذهبت مع محمد علوش لمطبعة نصار ، إندهش الرجل، ربت على أكتافنا ومنح كل منا ريالا فضيا بصورة الملك فاروق الأول ( ملك مصر والسودان ) ،ولم نعد للشعر إلا بعد هزيمة يونيو بعام واحد، في عام 1968، وفي العام التالي حصلت قصيدة ” المطبعة ” على شهادة تقدير من المؤتمر الأول للأدباء الشبان ، وتوقيع الشهادة باسم الدكتور مفيد شهاب ، الزقازيق ، ديسمبر 1969.

* رغم المكانة الأدبية لماذا لم تترك دمياط إلي ساحة أوسع كالقاهرة مثلا..؟
ـ هذا موقف واختيار ، حسمت الأمر مبكرًا ، ورأيت أن أظل في مدينتي التي عملت فيها صبيًا، وتعلمت منها الكثير خاصة فترة عملي في ورش الموبليات ثم في معارض بيع الاحذية.
لم تكن القاهرة تمثل لي إغراء ما، لكن من الضروري أن أشير إلى أن القاهرة البعيدة المستحيلة قد منحتني جوائزها الأولى رغم البعد الجغرافي ، إضافة إلى أن مزاجي الشخصي يخشي الابتعاد والاغتراب، وهو موقف له بعد سيكولوجي فأنا أكثر شعورًا بالأمن كلما كنت قريبًا من بيتي وحارتي ورفاقي، من حكاياتهم أشكل عجينة السرد بهدوء وتمهل ، في سنوات القص، ومادته الخشنة ، الحزينة ، تلك التي جاءت بعد سنوات من صهد الشعر وعلوه وسموه في سموات بعيدة.
* حدثنا عن دور المقهي في حياتك..؟
ـ حتى عام 2001 لم يكن المقهى يمثل لي شيئًا مهما باستثناء تجمعنا كل عيد فيه مع الزملاء الذين استقروا بالقاهرة ، منهم: محمد الشربيني ومجدي الجلاد وأحمد عبدالرازق أبو العلا . كانت الجلسة تضم محمد علوش، ومصطفى العايدي، ومحمد الزكي ، وكنت معهم.
بعد خروجي إلى التقاعد عام 2011 صار المكان تجمعًا يوميًا للكُتاب والكاتبات، نتباحث فيه ونتحاور في أمور الثقافة والأدب ، ندير حوارًا دائمًا مع الكتاب الجدد، ونعيش حالة مستمرة من الإبداع. نستضيف بورخيس ووليم فوكنر وتشيخوف ..
بشكل شخصي تعاظمت استفادتي من أجواء المقهى في كتابة عشرات المجموعات القصصية منها على سبيل المثال : ” الأبواب ” 2013 ، ” اللمسات ” 2015 ، ” الأستاذ مراد” 2016 ، ” فك الضفيرة ” 2020 ، ” قهوة على الريحة ” 2022.
في أغلب هذه النصوص تجد المقهى حاضرًا ، وشخصياتي عرفتها من الجوار ومن جلستي المتأملة للناس ، فأنا شديد الإنصات لبوحهم وأنينهم . ألست فردًا منهم ، في سعيهم الحثيث للعيش في واقع مضطرب ، فيه كثير من الفوضى والضغوط والآلام المتوارثة جيلًا بعد جيل ؟!
* ما الرافد الرئيسي الذي يستمد منه الفيل أعماله…؟
في أكثر من دراسة جامعية حول أعمالي توصل الباحثون أن الحياة في الحارة الدمياطية مصدرًا لكتاباتي ، كما أن عالم الطفولة هو الصندوق السحري الذي أعود إليه كلما نضبت أفكاري ، توقفت كذلك أمام تجربة التجنيد في مجموعة ” شمال .. يمين” 2007 ، وعنها كتب جورج جحا في تقرير لوكالة أنباء رويتر : ” أن هذا الكاتب وضع التجربة العسكرية في زي مدني ومواءمات إنسانية ” وعن نفس الفكرة كتب الدكتور محمد ابراهيم طه، وسيف بدوي، ودكتور عيد صالح ، منذ وقت مبكر.
* ماذا عن المرأة في قصصك؟
ـ في رسالة الماجستير المعنونة ب” الفن القصصي عند سمير الفيل ، قضاياه وسماته الفنية ” كتبت الباحثة هبة مبارك محمد زغلول :” عانت المرأة في قصص الكاتب ، وكابدت أقسى حالات القهر النفسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، لكنها على الرغم من ذلك كله ، استطاعت أن تصمد ، وأن تقف بثبات وكبرياء ، وتحافظ على شرفها وعقلها وكرامتها ، مؤثرة الصبر والتقشف ، والعمل الشاق المضني عن السقوط في مستنقع الإثم والرذيلة “.
أضيف أن المرأة في قصصي قوية ، ولها سطوة وحضور، كما رأيت ذلك بنفسي في حارتي الشعبية التي خرجت فيها المرأة للعمل في مهن جد قاسية كحمل ” المونة ” في صحافها الحديدية على الأكتاف، والصعود على السقالات في منظومة البناء مع انبعاث صوت المغني ” هيلا هيلا. . صلي ع النبي “.
الكاتب الذي لا يمتلك تلك الوصلة الحقيقية سوف تتبدد أعماله حتما.
* من الأدباء الذين أثروا في حياتك الإبداعية؟
كثيرون ، سأبدأ بأهمهم على الإطلاق:
صبري موسى الذي قابلته في بداياتي حيث كان يعمل صحفيًا في ” صباح الخير” وقرأ أعمالي الأولى وسرت معه في شوارع دمياط حين عاد ليتفقد مدينته ومدرسته الأولى التي تعلم فيها.
يحي حقي الذي قابلته بمدينة دمياط صيف أحد السنوات وسرت معه من مقر قصر الثقافة إلى موقف رأس البر وكان يتحدث بأبوة ودفء لم أجد مثله مع أحد آخر.
خيري شلبي، الحكَّاء البارع، الذي كان صديقًا للكاتب حسين البلتاجي فنجلس معه على المقهى ويمطرنا بحكاياته البديعة.
عبدالوهاب الأسواني الذي قابلته في ” الدمام ” ، وكان كنسمة صيف بلطفه وحكيه والاعتزاز الشديد بكرامته المهنية والإنسانية.
أنيس البياع ، الذي صدقني شاعرًا ثم وقف معي كاتبًا للنص القصصي وكتب عن تجربتي أكثر من دراسة ذات طابع جمالي، ويقف معه على نفس الدرجة الشاعر الدكتور عيد صالح الذي يمتلك حسًا نقديا شديد الرهافة والجمال إضافة إلى ظله الإنساني.
ومن ينسى السيد النماس ، الشاعر الكبير والمثقف الموسوعي الذي مدنا في بداياتنا بكتب مهمة جدا وخطط لمجموعتنا الشابة مسارا للقراءة، هل ننسى كتاب ” ضرورة الفن”؟
طاهر السقا ، حين عاد من ليبيا ، ومعه مجموعة اسطوانات للموسيقى الغربية فاستمتعنا ببيتهوفن وباخ وموتسارت، كما أتحفنا بأسطوانات سيد درويش العظيم، وبمسرحيات فيروز الغنائية ، أنا ومحمد علوش في زيارات يومية لبيته. .
محمد أبو العلا السلاموني الذي قدم تجاربي الأولى في المسرح ضمن خطة ” نادي المسرح” 1980، ومن انتاجي في تلك الفترة :” صهيل في البحيرة ” ، ” كلوا بامية ” ، ” قلم ووطن” ، ” راهب الليل”.
وكان المدير الفذ لقصر ثقافة دمياط وقتها هو محمد عبدالمنعم الذي أصدر لي أول ديوان منشور” الخيول”، 1982، وكان النشر وقتها معضلة كبرى..
هناك كتاب أثروا في توجهاتي من بينهم: ألبير كامو ، ديستويفسكي ، أنطون تشيخوف، نيقوس كازنتزاكي ، ألبرتو مورافيا وقد قابلته مرة في لقاء عقد معه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .
كما أن شعراء عظام قد أثروا في ذائقتي : صلاح عبدالصبور ، فوزي العنتيل، أمل دنقل ، حسن طلب، جمال القصاص ، علي قنديل، حلمي سالم ، وقد زارني في بيتي أكثر من مرة . وبالطبع محمد ابراهيم أبوسنة الذي كان يتمتع بأخلاق الفرسان.
أشير أيضا إلى فاروق شوشة الذي رشحني لكتابة برنامجين للإذاعة : ” وجوه من أكتوبر” ، ” صور أكتوبرية ” من إخراج مجدي سليمان.
أما أول من قدمني للجمهور فهو العم محمد النبوي سلامة ، صاحب أغنية عبداللطيف التلباني ” خد الجميل يا قصب “، وصاحب أغنية” صباح الخير” للثلاثي المرح .
* ماذا تعلمت من الصحافة أثناء فترة عملك في السعودية..؟
ـ عملت أربع سنوات بالسعودية ، والتحقت محررًا ثقافيا بجريدة ” اليوم” وهناك أجدت عمل الصحافة، وتعلمت الدقة وسرعة الإنجاز ، وسقوط ما يسمى ” الوحي في كتابة النص الأدبي” ، فأنت في الصحافة لابد أن تحرر موضوعا في ظل أي ظروف.
قادني اهتمامي بحركة الفن التشكيلي لزيارة معارض عديدة عقدت في المنطقة الشرقية ودخلت مراسم الفنانين: كمال المعلم ، عبدالله الشيخ، منيرة موصلي ، على الصفار ، عبدالرحمن السليمان ، وكان رفيقي في تلك الجولات الشاعر الكبير أحمد سماحة.
كلفني على الدميني بتحرير تقارير عن الفن التشكيلي في مجلة طليعية هي ” النص الجديد” ولما عدت للوطن اصدرت كتابا عن ” عبدالعزيز مشري وهو قاص وروائي سعودي مهم جدا. كان يعاني من مشكلة صحية هي الفشل الكلوي وظهر ذلك في مجموعتيه :” الزهور تبحث عن آنية” ، ” موت على الماء ” .
* ماذا أعطتك الكتابة….؟
ـ سؤال صعب ، سأحاول الإجابة عنه حسب قناعتي ، وأبتهل إلى الله أن تسعفني اللغة . أردت عبر كتاباتي أن أخفف من غلواء نفسي ، أن أفك شفرة العالم من حولي بشكل ما ، أن أعبر عن ذاتي وعن شركاء حارتي الفقيرة والمعوزة. وقد منحتني الكتابة بعض أسرارها وأخفت عني البعض الآخر بالرغم من إخلاصي لها.
يبدو أن تلك الدرجة من الإخلاص لم تكن كافية. منحتني الكتابة حب الناس ، التواضع لأنك ستفهم حتما أنك ذرة في الكون ، وأنه لا مجال للتعالي أو ” الانتفاخ” . لكن أهم ما منحتني الكتابة إمكانية اللعب مع اللغة بعقل صاف، و قلب مترع بالمحبة ، والوعي بضروريات ميدانية ، أهمية الإنصات لحكايات الناس مهما بدت بسيطة ، فعليك ـ وحدك ـ تقع مهمة الحفر بدأب في الأعماق لعلك تحصل على ” قطعة الماس “؟!
* ما تأثير دمياط علي مسيرتك الأدبية…؟
ـ أنا ابن مدينة حرفية هي دمياط، انخرطت في دولاب العمل مبكرًا قبل التحاقي بالمدرسة ، من ورشها تعلمت معنى الدقة ، وسرعة الإنجاز ، وأهمية البعد الجمالي ( حرفة الأويما أي الحفر على الخشب ) ، في سوق بيع الأحذية تعرفت على أنماط من البشر لهم نزواتهم وانكساراتهم وزهوهم، وألاعيبهم العجيبة ( راجع مجموعتي ” صندل احمر” التي كتبت عنها انتصار عبدالمنعم بوعي ورهافة) .
المدينة تدفعك للجدية ، واقترابها من البحر يدفعك للتحرر من القوالب الجامدة، نزوعا للتحرر من الثقل الأرضي.
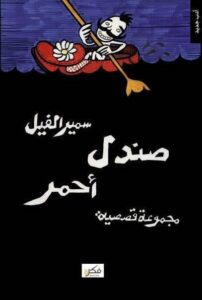
لكن البشر هم هم ، لا يتغيرون إلا بمقدار ، في تلك المدينة تسمع مصطلح ” المصلحة ” طول الوقت ؛ فالبيت دوره الأرضي ورشة ، وفي الطوابق سكانه ومنهم الأسطى ، فوق السطح دواير الحمام. الأسطح المتلاصقة تبوح ببعض أسرارها والكاتب الفطن هو الذي يستفيد من تلك التداخلات.
دمياط القديمة كان يأتيها الفيضان، فيصل لعتبات البيوت ، وكانت أسراب السردين توجد بشكل كثيف ، والكابوريا تباع ب” الصفيحة “. دمياط ذاتها ورشة كبيرة لصناعة الموبليات ، والأحذية ، ومنتجات الألبان، والمشبك . وفيها يباع ” الطير المهاجر ” بالتورة” وهي ” أربع فرد من الشرشير والبلبول والمستكاوي والحمراي والخضير. ” الغر ” وحدها الذي يحمل الزفارة؟!
يشعر صناع الأثاث بالتميز وأحيانًا يتعالون على الموظفين. هذا عصر انتهى حيث شهد المدينة ركودا لافتا ، والأسباب مختلفة .
نهاية القسم الاول


