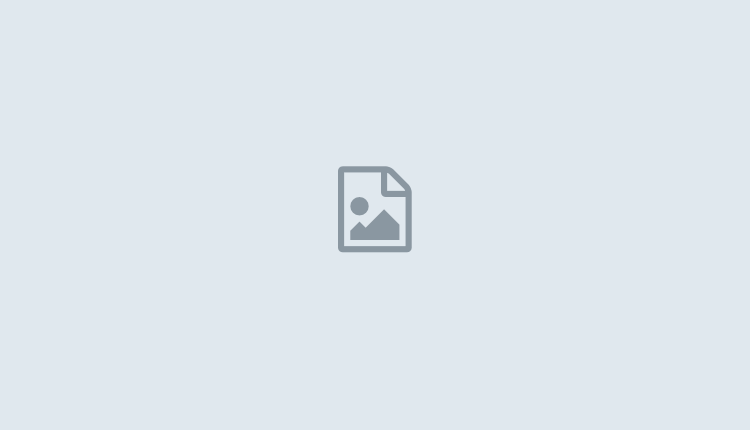محمد علي جواد تقي
التربية الأخلاقية في المدارس والجامعات يحتاج الى منهج عملي متكامل الى جانب المنهج النظري (الكتاب) الذي اقترحته وزارة التربية في العراق مؤخراً لطلبة الأول الابتدائي، وكتاب آخر لطبة الأول المتوسط، فالأمر يحتاج عملية تثقيفية تنساب الى جميع مرافق المؤسسة التعليمية، من الحارس عند الباب، ومن ثم الإدارة والكادر التدريسي، وبعدها الطلبة…
ابتعاد التعليم عن الأخلاق حصل بسبب تفسيرات عرّفت العلم على أنه مطلب عام بينما الأخلاق مسألة شخصية، وأن العلم اكتسابي، بينما الأخلاق سلوك وخصال محتّمة على البعض دون الآخر لاسباب عدّة، ترافقه من ولادته وحتى مماته.
فمن الطبيعي –لدى البعض- وجود الطالب المؤدب الى جانب الطالب المشاكس في المدرسة، لأن المطلوب من الاثنين التعلّم بجد واجتهاد وإحراز المراتب العليا، وهو الشغل الشاغل للتلميذ من مراحله الابتدائية الى الاعدادية، وحتى في مرحلة الجامعة، وليس المهم أن يكون صادقاً أو متسامحاً، أو أميناً، او متواضعاً، حتى وإن عرف الجميع أن هذه الصفات ونقيضها ستطبع سلوك وطريقة عمل ذلك الطالب عندما يكون محامياً، او طبيباً، او مديراً لدائرة حكومية.
بلى؛ ثمة مبادرات فردية في المدارس لنشر الثقافة الاخلاقية بين التلاميذ والطلاب، تعود الى ثقافة الكادر التدريسي وحرصهم على الجانب المعنوي في التعليم، بيد أن القضية بحاجة الى منهجية متكاملة لتتحول لدينا ثقافة أخلاقية تعمّ الجميع.
هذا الواقع المرير هو الذي انتزع مصداقية التربية من مشروع التعليم ليبقى اسماً دون مسمّى في عنوان الوزارة المعنية في معظم البلاد العربية والاسلامية، رغم تنبّه العلماء والحكماء للقضية منذ البداية، ويتركز الجهد على التعليم في جانب الكادر، من معلمين ومدرسين، وفي جانب الطالب ايضاً، وصار هدف المدرسة وشعارها؛ نجاح الطالب، فهي تفتخر به وتكسب من وراءه الامتيازات لدى مديرية التربية في المدينة، ولدى الوزارة ، كما يفتخر الطالب بنفسه ايضاً.
الحتمية اللاتربوية
حاول علماء النفس والاجتماع صياغة رؤية محددة لسلوك الانسان لتحديد شخصيته، ثم الدوافع والمحفزات لديه نحو القيام بأي عمل، فتوصلوا الى عدة نظريات نسلط الضوء على أثنين منها:
1- نظرية الطبيب الروسي بافلوف المختص في أمراض الجهاز الهضمي، المعروفة بـ”المنعكس الشرطي”، وقد توصل اليها صدفة فيما كان يريد قياس مقدار افرازات فم الكلب لديه عندما يقدم له طعامه، فلاحظ أن مجرد اقتراب الطعام يسيل لعاب الكلب، فدفعه لمزيد من البحث والتحليل ليصل الى نظرية تربط بين سلوك الانسان والمثيرات من حوله فتكون له استجابات شرطية، فوجود المثير هو المسبب لردة الفعل، وقد مثلوا بوجود جرس الطعام على الطاولات في مطاعم اوربا في بدايات القرن الماضي بوجود حاجة للزبون الى الطعام.
ولا نناقش في أصل الفكرة ومدى صحة مقارنة الحيوان بالانسان في مسألة حساسة كهذه، إنما الملاحظ إقصاء دور التربية في تهذيب وتقويم سلوك الانسان، بمعنى أن وجود الصور المثير جنسياً أمام الشاب –مثلاً- تحتم بالضرورة انجذابه الى هذه الصور، وتفاعله معها، ومن ثم تحول هذا التفاعل الى سلوك عملي نلاحظه في الاخبار التي تعجّ بها وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه النظرية تستبعد دور العقل في تنظيم السلوك، وتضع الانسان أمام حتمية لا تربوية يعيش فيها صراعاً أبدياً مع نفسه ومع محيطه الاجتماعي، بين القبول والرفض، وبين الصحيح والخطأ دون وجود ضوابط ومعاييرتضمن له الحد الأدنى من الوقوع في الخطأ.
بالمقابل قدم علماء الأخلاق نظرية تهذيب النفس؛ ليس لقمع الغرائز الطبيعية لدى الانسان، وإنما لتوفير الكوابح والعلامات التحذيرية للعواقب السيئة لهذا العمل او ذاك، وليستفيد الانسان في من الغريزة الجنسية –مثلاً- بالشكل البناء، كما يستفيد ايضاً من غريزة حبّ الأنا لمعرفة ذاته والعمل على تطويرها في المسارين؛ المادي والمعنوي.
2- النظرية المادية التي توكل الانسان الى نفسه وما يحمل من صفات تعود الى عاملي الوراثة والمحيط الاجتماعي وتضعه أمام قدره الذي لم يختاره بإرادته بالضرورة، وإن كان أبواه غير سويين أخلاقياً –مثلاً- أو نشأ في بيئة غير سويّة ولا مهذبة، فهو محكوم عليه بالانحراف أبداً، ويمثلونه بالثمرة المرّة التي تنبت من شجرة مرّة، وفي الاوساط الدينية يتعكّز البعض على الحديث النبوي الشريف لتعضيد هذا الرأي بأن “الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة”، علماً أن التدبّر في هذا الحديث يرشدنا الى التعددية والتنوع الذي يبشّر به النبي الأكرم لمجتمعنا الاسلامي، لا أن يتحول الافراد الى صفائح معدنية متنوعة كلٌ له قيمته الخاصة مثل؛ الذهب والفضة والنحاس والحديد!
علماء الأخلاق احتجوا على هذا الرأي بنجاح الرسالات الإلهية في تربية الانسان وتغيير أخلاقه وسلوكه، من القسوة والغلظة، والعدوانية، والاحتراب الى التسامح والوئام والحب، ولا أدل من تجربة النبي الأكرم مع عرب الجزيرة العربية ونجاحه الذي أبهر العالم في تغيير أخلاقهم مئة وثمانين درجة، فقد كانت فترة حياته معهم عبارة عن تربية أخلاقية حتى قيل أن كثير من الشعوب حول العالم استجابت لنداء الإسلام طيلة القرون الماضية من خلال لغة الأخلاق فقط.
من النظرية الى التطبيق
التربية الأخلاقية في المدارس والجامعات يحتاج الى منهج عملي متكامل الى جانب المنهج النظري (الكتاب) الذي اقترحته وزارة التربية في العراق مؤخراً لطلبة الأول الابتدائي، وكتاب آخر لطبة الأول المتوسط، فالأمر يحتاج عملية تثقيفية تنساب الى جميع مرافق المؤسسة التعليمية، من الحارس عند الباب، ومن ثم الإدارة والكادر التدريسي، وبعدها الطلبة، كل هؤلاء تتضافر جهودهم لتكريس ثقافة الاحترام والثقة بشكل متبادل.
وكما أن المدرسة تدعو الأسرة لمساعدتها على تحقيق النجاح للطالب، فان المشروع التربوي يحتاج لجهود من أطراف ذات علاقة بالطالب والكادر التدريسي معاً، فالى جانب الأسرة، يمكن للمؤسسة الدينية الإسهام بدور فاعل ومؤثر بشكل مباشر لنشر التربية الاخلاقية في المحيط التعليمي من خلال تفعيل دور المساجد والجوامع وتجسير العلاقة بينها وبين المدرسة والجامعة، الى جانب توثيق العلاقة بين الخطباء والعلماء وبين الطلبة والكادر التعليمي.
وهنا تجدر الإشارة الى التجربة الناجحة لحضور خطباء المنبر الحسيني في الجامعات العراقية، وقبلها في المدارس لفتح مواضيع بقيت لفترة طويلة حبيسة قلوب الشباب دون أن تجد إجابات مقنعة تنفس الهمّ، مثل؛ اكتشاف الذات واحترام الآخرين، والعلاقات بين الجنسين، والحجاب، والتوازن بين العقل والعاطفة، والكشف عن العلاقة العضوية بين الدين وحياة الانسان.
إن حضور خريجي الحوزة العلمية من ذوي القدرات العلمية والعمق الثقافي في المراكز التعليمية بشكل عام يحل إشكالية ذهنية طالما ألقت بظلالها على طريقة تفكير الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بخصوص دور الدين في الحياة، وهل إن كل المطروح إعلامياً وتثقيفياً ينحصر في إطار الزواجر والنواهي والأوامر؟ أم إن القضية تتعلق ببناء إنساني برؤية حضارية تقدمية تواكب الزمن وتطور الانسان نفسه؟
وقد نبه القرآن الكريم الى مفهوم “التذكير” كأحد مهام الانبياء والمرسلين من السماء الى بني البشر، ثم توصل الانسان الى طريقة مشابهة للتوصل الى الحقائق اسماها “التكرار” وهو ما نجد بصماته واضحة في التربية والتعليم في العالم كله، وحتى في الدعاية والإعلام للتأثير في عقول ومزاجات الناس، بل والتأثير في حياتهم بشكل عام.
إن الدعوة الى إبعاد العلم عن المادة مطلبٌ جماعي محبب من الجميع، ولكن تحقيقه على ارض الواقع يكاد يكون مستحيلاً في الوقت الحاضر، فالطالب؛ وهو على مقعد الدراسة يتطلع لأن يكون ثرياً من خلال شهادته الجامعية، ثم تلاه فيما بعد المدرس من خلال انحراف التعليم نحو الخصخصة، كمدارس وجامعات، ومن ثمّ، دروس التقوية التي تطورت من البيوت لتتحول ال معاهد كبيرة بأبنية فاخرة، مما يستدعي البحث في ثقافة المسؤولية وطريقة إثارتها في نفوس التلاميذ ثم طلاب الاعدادية وحتى الجامعة، بأنهم ليسوا مسؤولون عن أنفسهم وعن مستواهم العلمي، وان يكونوا متفوقين دائماً، إنما هم مسؤولين ايضاً عن محيطهم الاجتماعي، فهم لن يفلحوا في شيء مادام الفشل والانحراف والجهل يحوم حولهم، وإن كان أحدهم طبيباً بارعاً، او مهندساً مبدعاً، او علامة زمانه في الاقتصاد والقانون والكيمياء والفيزياء.
وبما أن ثلّة من الخطباء والعلماء الحاملين للوعي والثقافة العميقة، لم يدرسوا أحكام الحلال والحرام فقط، وإنما اشتملت دراستهم على المنطق، والتاريخ، والاجتماع، والاقتصاد، والسيرة، والقرآن الكريم، والأخلاق، والعقائد، وكلها علوم معمّقة قادرة على الإجابة الى كل الاسئلة والاستفهامات بطريقة توفر الوقت والجهد على صاحبها من الاتكال الى المصادر المعرفية الأخرى لتجعله يتفرغ لبناء شخصيته العلمية والثقافية خلال مسيرته التعليمية.