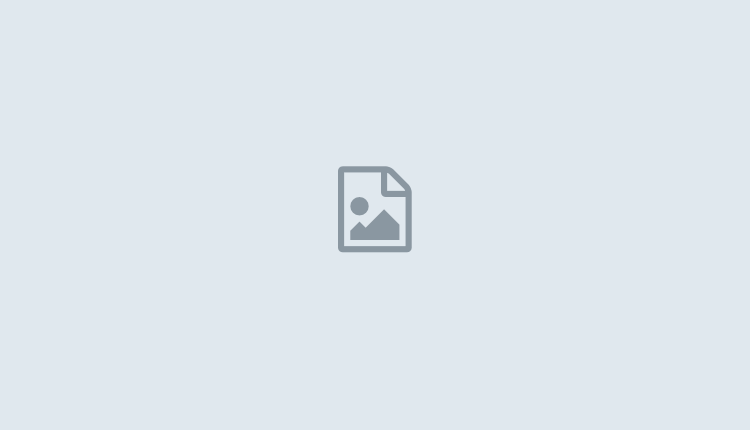طلال سالم الحديثي
عرفته في الستينيات حين كان يدرس مادة الفلسفة الاسلامية لطلبة اللغة العربية في كلية الآداب/ جامعة بغداد وكنت أيامها حديث عهد بالدرس الفلسفي المنهحي الا أن أسلوب مدني صالح وطريقة ألقائه الدرس وغزارة معلوماته كانت وراء انشدادي وزملائي الى درسه.
ولعل أول ما أثار دهشتنا منه، طلبه الينا في أولى محاضراته، احضار نسخة من كتابه (الوجود) ان وجدت عند أحدنا، ويومها ظننا بالرجل ظن السوء فحسبناه كغيره من الأساتذة الذين يروجون لكتبهم، ولكن المفاجأة ألجمتنا حينما أخبرنا بأنه يجمع نسخ كتابه (الوجود) ليحرقها، لأنه وجد بعد طبع الكتاب أن الآراء الواردة فيه بحاجة الى تغيير وحذف ومراجعة وتصحيح لا يمكن أن تتم ألا بأحراق الكتاب!
فصرت أيامها شديد الحرص على ألا تفوتني دقيقة من درسه الاسبوعي الذي يأتيه عجلا ويخرج عند نهايته عجلا والذي أحببت فيه دقة الآراء المطروحة وجدتها والجرأة في نقد غيره وقدرته الفذة على استيعاب النصوص وما حولها وما عليها.
وحدث ذات درس أن وزع علينا أوراقنا الامتحانية في مادة درسه، وكان من عادته أن يقرأ أسم الطالب ثم يسلمها أليه، ولما قرأ أسمي وضع ورقتي جانبا ولم يسلمني إياها ثم قرأ أسم الطالب الذي بعدي وأخذتني الهواجس وحسبت أن علامتي متدنية جدا فلم يشأ احراجي، لكنه بعد أن انتهت المحاضرة نهض مسرعا كعادته وناداني باسمي قائلا لي: اتبعني الى غرفة الأساتذة. وتبعته الى هناك، فأجلسني جانبه ثم سألني: أأنت الذي كتب مقالا في مجلة «الأديب» اللبنانية عن الدكتور جلال الخياط، (معقبأ) على اطروحته حول الشعر العراقي الحديث ومصادر دراسته؟ فأجبته بالإيجاب، فقال: لا تبدأ حياتك الأدبية بالتعقيبات، وهذه ورقتك الامتحانية وعد الى صفك. (كانت قد مرت خمس سنوات على نشر مقالتي التي سألني عنها ألا أنه يتذكرها جيدا).

منذ ذلك الحين بدأت أحييه ويحييني كلما ألتقينا، وبدأت أبحث عن كتبه المطبوعة ومقالاته المنشورة في الصحف والمجلات، فقرأت كتابه (الوجود) وقرأت كتابه (أشكال ألوان) وكتابه هذا مجموع أراء ونظرات في الحياة والأدب والسياسة على عكس كتابه (الوجود) ومادته فلسفية بحتة.
وقد أستوقفني في كتاب (أشكال ألوان) ما ذكره منتقدا العهد الملكي بأسلوب التورية الذي يبرع فيه، قال: (البيداء بيداؤنا، والبعير ليس بعيرنا). وأظن أن كثيرا من القراء لم يقفوا على هذا الكتاب الفريد المطبوع في خمسينيات القرن الماضي.
وأذكر ذات مرة ألتقيته فيها عند مدخل شارع المتنبي حاملاً كتاب الدكتور إحسان عباس عن بدر شاكر السياب، فاستوقفني سائلا: ما الكتاب الذي اشتريته؟ فأريته الكتاب، فقال بالنص وعلى الفور، قصة عظيمة، ولكنه ككتاب نقدي لا يساوي شيئا، ومضى الى سبيل حاله عجلا كعادته.

وعندما عرضت عليه مسودة كتابي النقدي الأول (مقدمة وستة شعراء) قبل، طبعه عام 1970م، فقرأها- وأيامها كان لايزال أعزبا يقيم في فندق يقع في ساحة حافظ القاضي، وحينما ذهبت اليه لأستلم نسخة كتابي المخطوط منه وأسمع رأيه فيه، لم يقل سوى كلمة واحدة نطقها بالإنكليزية قائلا: (براكتس) أي تمارين.
وتتابعت قراءتي في كتبه التي هي في أغلبها مقالات ينشرها في الصحف والمجلات ثم يطبعها في كتاب ومنها: هذا هو السياب، وهذا هو البياتي. وكان يفضله على السياب، وهذا هو ألفارابي، ومقامات مدني صالح الاولى، ومقامات مدني صالح الثانية، ودراسته عن ابن طفيل، وقصة حي بن يقظان وله أيضا: الفيلسوفة رباب، وبلال والجميلة رباب، وبقايا التجربة، التربيع والتدوير، الغزالي ومناهج الارتقاء من أفلاطون الى ديكارت، وبعد الطوفان. ورواية مخطوطة بعنوان (خان شاحوذ) ولست في معرض الثناء على كتبه، فالرجل له اجتهادات يقولها بصيغة الرأي، يرضى بها من يرضى، ويغضب منها من يغضب، وأشد الغاضبين على أرائه النقدية كان المرحوم الدكتور علي جواد الطاهر، وكان ينتقد نقاد الأدب- وخاصة من يمارسه من أساتذة الجامعة- لأنهم حسب رأيه يصبغون أراءهم النقدية بصبغة (التمذهب) فيرفعون من لا شأن له ويحطون من مكانة غيره لهذا السبب. وقد حدثني هو يوما عن هذا الأمر، كما حدثني عن المرحوم علي الوردي الذي يعده باحثا اجتماعيا عراقيا فريدا.
والتقينا عند (سوق الفتح)، فتندر قائلا: أي فتح هذا، والعراقي يلبس (اللنكات) وهو أبو النفط؟! ثم اخذني الى زقاق ضيق قرب ذلك السوق وفيه محال لبيع الخضر فقال: عن هذا الزقاق كتب كاتب انجليزي أسمه كانتر بري رواية ممتازة، ثم اتجه الى بائع لحوم وسأله عن سعر الكيلو غرام من اللحم؛ فأخبره البائع حينها ان سعره (خمسة الاف دينار) فقال له: أعطني كيلوغراما واحدا قبل ان يصبح سعره (ستة ألاف) دينار ولا أستطيع شراءه .

ومرة دعاني الى الغداء في مطعم شعبي، وقد اصطحبني بسيارته القديمة، وهي السيارة التي أمتلكها هدية من وزارة التعليم العالي أيام صدور قانون الكفاءات الذي كرم بموجبه أساتذة الجامعات بسيارة لم يمتلك جلهم غيرها لأنهم كانوا من ذوي الدخل المحدود الذي لا يكفي لسد احتياجاتهم ولا يفي بمتطلباتهم المعيشية، وقد بقي أغلبهم يتنقل بالحافلة وكان مدني يزور جريدة «القادسية» أسبوعيا ليسلم مقالة زاويته الأسبوعية (أشياء وأشياء)، قال لي بعد صمت عرف به: يا طلال أتعرف بم كنت أفكر؟! فأجبته بالنفي، قال: كنت أتساءل مع نفسي فأقول: لو أصبحت يوما وزيرا للتربية لألغيت مناهج الدراسة الابتدائية الحالية لأنها مناهج تقوم على الكم، والكم هو سبب مأساة التعليم في العراق، فالطفل يحشى دماغه بالمعلومات التي يذهب أغلبها لعدم أدراكه الكثير منها، الطفل في الصف الأول يكفيه أن يعرض عليه المعلم (تفاحة) ويقول له: هذه تفاحة، والتفاحة هذا هو شكلها، ولها لونان أصفر وأحمر، فتنطبع صورتها في ذهنه فلا ينساها طوال حياته لأنه لابد قد ذاق طعمها.
لقد كانت مناهج الدراسة في المدارس العراقية ومازالت تسير وفق المنهج الكمي الذي كان السبب في رسوب نسب كبيرة من الطلبة أدت الى تركهم الدراسة، وأذكر أن كتاب مادة (الجبر) للصف الثاني المتوسط كانت مادته تعادل أية مادة يدرسها الطالب في الجامعة، وكتاب (التاريخ الأوربي )، للصف الخامس الأدبي يتفوق حجمه على كثير من الكتب التي يستعان بها في مرحلة الدراسة الجامعية.
ان أراء مدني صالح الفلسفية والنقدية كانت تتسم بالجرأة التي يتسم بها كمفكر حر مستقل الرأي لا يصده عن ابراز رأيه خوفاً من سلطة أو زلفى لجهة ما، فقد كان على يقين أن رسالته العلمية تنأى به عن الملق والتزلف لأصحاب النفوذ ورجال السلطة، فبقي في كرسيه الجامعي لم يصفق لأحد ولم يمتدح أحدا، وكان مبتغاه أن يقول كلمته ويمشي، وظل هكذا ديدنه في الحياة، يقطع الطريق من داره في العطيفية في بغداد الى مدينته (هيت) حتى تغير نظام الحكم في العام ،2003 فنأى بنفسه معتكفا في داره لا يبرحه حتى وفاته حزينا مقهورا تناوشته أمراض كثيرة، ولم يعد بإمكانه ان يصل الى كلية الآداب متخطيا الاسلاك الشائكة التي حالت بينه وبين درسه الفلسفي.